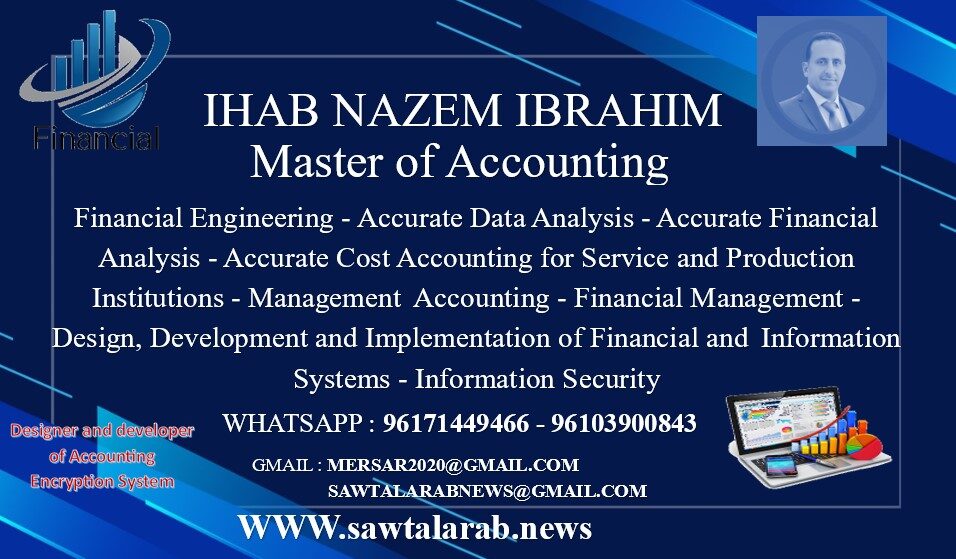المقدمة
لطالما شكّل الانقسام السني الشيعي أحد المحاور الأساسية في تاريخ المنطقة، إلا أن أطر هذا الخلاف توسعت بشكل غير مسبوق في العقود الأخيرة، متأثرةً بجملة من المتغيرات السياسية والاستراتيجية، وأبرزها التدخلات الخارجية. وإذ يُعدّ التباين المذهبي بين السنة والشيعة قائماً منذ قرون، فإن تحوله إلى صراع مفتوح لم يكن مجرد نتيجة للخلافات الدينية، بل جاء كنتيجة حتمية لتوظيف هذا الانقسام في مشاريع إقليمية تهدف إلى فرض الهيمنة وإعادة تشكيل موازين القوى.
من بين أبرز هذه التدخلات، برز الدور الإيراني بوضوح، حيث عملت طهران على دعم حركات وتنظيمات سياسية وعسكرية شيعية في عدة دول عربية، متذرعة بحماية “حقوق الطائفة”، فيما يرى خصومها أن هذا الدعم لم يكن إلا وسيلة لتعزيز نفوذها الإقليمي. وفي المقابل، لم تكن القوى السنية بمعزل عن هذا الصراع، إذ دعمت بعض الدول السنية جهات مناوئة للمحور الإيراني، ما أدى إلى تصعيد مستمر أشعل المنطقة وأدخلها في دائرة من العنف والانقسامات العميقة.
جذور الخلاف: عقائدي أم سياسي؟
يُطرح التساؤل الأبرز: هل الخلاف بين السنة والشيعة ذو جذور عقائدية أم أنه صراع سياسي تُغذّيه المصالح الإقليمية والدولية؟
من الناحية العقائدية، يتمثل الخلاف الأساسي في مسائل الإمامة والخلافة، حيث يرى السنة أن السلطة السياسية يجب أن تكون قائمة على مبدأ الشورى والاختيار، بينما يؤمن الشيعة بإمامة أهل البيت وحقهم الحصري في الحكم. لكن هذه الاختلافات الفكرية لم تكن سبباً مباشراً في الحروب والصراعات الدموية عبر التاريخ، بل ظلّت محصورة في الأطر الدينية والفكرية.
أما من الناحية السياسية، فقد كان للصراعات بين الدول الكبرى تأثير مباشر في تأجيج هذا الخلاف، حيث استُخدمت الانقسامات المذهبية كأدوات لتحقيق أهداف سياسية. فمنذ الثورة الإيرانية عام 1979، اتبعت طهران استراتيجية قائمة على تصدير نفوذها من خلال دعم الجماعات الشيعية في المنطقة، . بالمقابل، تحالفت دول سنية مع قوى مناوئة لهذا المشروع، مما جعل الصراع يخرج من إطاره الديني إلى كونه حرباً بالوكالة تخدم مصالح القوى الكبرى.
إلى أين وصل الخلاف؟
في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة، باتت خطوط الصراع أكثر تعقيداً، حيث امتد الانقسام ليشمل تحالفات دولية وإقليمية واسعة. فمع تصاعد الدور الإيراني، تشكّلت جبهة مضادة تقودها دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، وتركيا، إضافةً إلى انخراط الولايات المتحدة وإسرائيل في دعم استراتيجيات تحجيم النفوذ الإيراني.
وقد أدى هذا الاصطفاف إلى تفاقم الأزمات في عدد من الدول العربية، حيث أصبحت الحروب الأهلية في العراق وسوريا واليمن ولبنان ذات طابع مذهبي حاد، حتى وإن كانت دوافعها الحقيقية سياسية بحتة. وباتت بعض الدول ساحة حرب مفتوحة بين المحاور المتصارعة، حيث تحولت الميليشيات والجماعات المسلحة إلى أدوات لخدمة أجندات خارجية، مما جعل الحلول السياسية شبه مستحيلة.
هل من مخرج؟
في ظل هذا التصعيد، تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في مفهوم الصراع وإلى ضرورة التمييز بين الخلاف الديني المشروع، وبين التوظيف السياسي للصراع الذي لا يخدم سوى القوى الخارجية. فلا يمكن تجاهل حقيقة أن استمرار الانقسامات يخدم مصالح دول كبرى تسعى إلى إبقاء المنطقة في حالة عدم استقرار لضمان هيمنتها الاقتصادية والسياسية.
إن الحل لا يكمن في مزيد من الاصطفافات، بل في إيجاد قنوات حوار حقيقية بين الأطراف المختلفة، وفرض رؤية استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة بدلاً من الأحقاد الطائفية. وعلى الشعوب العربية أن تدرك أن من يدفع ثمن هذه الصراعات ليس سوى المواطن العادي، الذي يجد نفسه عالقاً في دوامة العنف دون أن يكون له فيها ناقة أو جمل.
الخاتمة
لقد تحوّل الخلاف السني الشيعي من كونه انقساماً عقائدياً إلى سلاح في يد القوى الإقليمية والدولية، حيث يُستخدم كأداة لإعادة رسم خريطة النفوذ السياسي في الشرق الأوسط. وبينما يواصل هذا الصراع حصد الأرواح وتدمير المجتمعات، يظل التساؤل قائماً: إلى متى ستبقى المنطقة رهينة لهذا الاستقطاب المدمر؟
إن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وعياً جماعياً يرفض أن يكون جزءاً من لعبة الآخرين، وإدراكاً بأن المصالح الوطنية والقومية يجب أن تكون فوق أي انتماء طائفي. فلا يمكن أن تبقى الأمة العربية رهينة لمعادلات صراع تخدم مشاريع لا تمت لمصلحة شعوبها بصلة. فهل آن الأوان لكسر هذه الدائرة الجهنمية، والعودة إلى منطق الدولة والمؤسسات بدلاً من منطق الميليشيات والطوائف؟